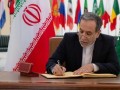الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الفلسطينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب فلسطينية
- بطولات
- أخبار الاندية الفلسطينية
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- صور
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
ذاكرة الشتات

بقلم :رجب أبو سرية
لعلها المصادفة وحدها التي جعلت من «المعركة الأخيرة»، التي يدور رحاها حول وداخل ما تبقى من مخيم اليرموك الفلسطيني، القريب من العاصمة السورية، دمشق، أن تحدث على بعد أيام فقط من حلول الذكرى السبعين لنكبة العام 1948، وإذا كان إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ضاعف من مأساوية الذكرى، من حيث إن فصولها ما زالت قائمة بعد سبعين عاماً دون أن ينجح المجتمع الدولي في وضع حد لها، فإن تدمير ما تبقى من مخيم اليرموك يزيد من وقع المأساة ويعدد فصولها لتصبح متوالية لا تنتهي.
المشكلة تزداد حين ندرك أن الموقف العقلاني بتحييد المخيم عن الحرب الداخلية في سورية، والتي اندلعت فصولها قبل سبع سنوات، لم يجد طريقه، ما أدى لتدمير معظم المخيم وتشريد الغالبية الساحقة من سكانه، إلى أقاصي الأرض، كذلك يجري الفصل الأخير في جعل المخيم أثراً بعد عين، والإخوة منشغلون بصراعهم حول كيفية إنهاء الانقسام الداخلي.
واليرموك ليس مخيماً عادياً أبداً، ولم يكن أكبر مخيمات سورية وحسب، بل كان يعد عاصمة الشتات، الذي احتضن قيادات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وضم بين ترابه الكثير من شهدائها، كما أنه كان يعتبر بحق ذاكرة الشتات التي تجعل حلم العودة ماثلاً، طال الزمان أم قصر.
في اليرموك كانت تحضر خارطة فلسطين بمدنها وقراها، وتتوزع أسماء المدن، من صفد إلى لوبية، ويتجمع الفلسطينيون محتفظين بذاكرتهم من أبناء الطيرة وصفد ولوبية، لتظهر معهم وفيهم كل سمات الشعب الفلسطيني، حيث لم تخل مناسبة إلا وكنت تشاهد الثوب الفلسطيني والعلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية، فيما المعارض والبوسترات تزين المحال والشوارع في كل مناسبة وطنية.
كان اليرموك مخيماً فلسطينياً حياً ونابضاً بامتياز، فلا يمر يوم إلا وتكون هناك فاعلية أو مناسبة ترى فيها فلسطين بكل ألقها وحضورها، لا تغيب لا عن بال ولا عن حاضر الأجيال الفلسطينية المتعاقبة.
لذا، فإن يخرج اليوم، نحو نصف مليون فلسطيني من دول الجوار إلى المنافي البعيدة، فإن ذلك يجعل حتى من توقهم ومن فعلهم على طريق العودة أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، وهذا ما كانت تحلم به إسرائيل، أي إبعاد اللاجئين عن حدودها، حتى لا يجيء يوم وتكون هناك مسيرة عودة، كما يحدث على حدودها مع قطاع غزة هذه الأيام.
ثم أن يتم تدمير المخيم بالكامل أو مسحه عن وجه الأرض، فإن ذلك يجعل منه «وطناً داثراً» كما حدث مع قرانا الأربعمائة التي قامت إسرائيل بمسحها عن الوجود لإخفاء معالم جريمة اغتصاب فلسطين، وهذا يعني طي ذاكرة الشتات التي بقيت حافظة لحلم العودة.
يقيناً، إن أهل صفد ولوبية والطيرة وكل مدن وقرى شمال فلسطين الذي كانوا قد لجؤوا إلى سورية وأقاموا في اليرموك «وطن العودة»، يحتفظون الآن في ذاكرتهم الحية بمعالم وشوارع المخيم، وكل ما حدث فيه من مناسبات على مدى أكثر من ستين عاماً، وإنهم لن ينسوها أبداً، لذا فلا بد من جمع تلك الذاكرة، للحفاظ على ذلك الجزء العزيز من الذاكرة الوطنية حياً، لأنه جزء مهم من تاريخ الشعب والثورة الفلسطينية.
في مخيم اليرموك، نشأت عشرات الفرق المسرحية والعديد من الفرق الغنائية التي بثت الحماس في صدور الأجيال الشابة، وأقيمت عشرات المقار لفصائل الثورة، وتم إحياء آلاف المناسبات الوطنية، وفي مخيم اليرموك عرف جيل ما بعد نكبة العام 1948، أنه فلسطيني، وتعلم كيف يكون ويظل فلسطينياً، وفي مخيم اليرموك عرفت مئات الآلاف من الفلسطينيين، معنى الوحدة الوطنية، ومعنى التكافل الاجتماعي، وبين جنبات المخيم العظيم، ولد عشرات المبدعين الفلسطينيين من شعراء ومسرحيين وتشكيليين، وكانت مفردات المخيم حروف أغانيهم وإيقاع نبض قلوبهم.
لن تنسى الذاكرة الفلسطينية أبدا مخيم اليرموك، ومن أجل هذا لا بد من فعل مضاد لما يحدث حوله وفيه من دمار أخير، واليرموك لم يكن مثل بيروت على أي حال، ففي بيروت كان الوجود الفلسطيني عابراً واستثنائياً وضيفاً، أما في اليرموك فقد تم بعث فلسطين مجدداً بالسياسة والجغرافيا معاً، فقد كان مخيم اليرموك مجسماً لفلسطين على مقربة من دمشق، قلب العروبة النابض، وأقرب عواصم العرب إلى الوطن السليب.
في الذكرى السبعين للنكبة، وكرد على إعلان ترامب، لا بد من جعل المناسبة ورشة عمل، أو مؤتمراً لحق العودة واستمرار الحلم بها، لا بد من التفكير بإطلاق «متحف اليرموك»، للحفاظ على كل ما أنتجه التراث الحي لشعب رفض أن يموت وظل يحلم بالعودة، حتى لا نكرر ما حدث عام 1948، بالاحتفاظ بالذاكرة شفاهة وحسب.
هناك عشرات الأفلام التي صورت في مخيم اليرموك، وهناك عشرات المسرحيات التي أنتجت وعرضت في اليرموك، وآلاف الملصقات، وهناك القاعات التي شهدت جنباتها وقائع وأحداثاً وطنية غاية في الأهمية، وهناك شواهد قبور الشهداء، لا بد من توثيق كل هذا والاحتفاظ به، كجزء من التراث الوطني الفلسطيني، فالشعوب لا تندثر حين تنهزم عسكرياً وسياسياً، بل حين تتبدد ذاكرتها الثقافية، ولعل في بعث شعر المقاومة الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي للهوية الفلسطينية، لنا درس ما زال ماثلاً للعيان، وفي الاحتفاظ بما أنتجه اليرموك من ثقافة وفن فلسطيني، ما يضيف للتراث الثقافي الفلسطيني الكثير، من البوستر إلى فرق: العاشقين، بيسان، زغاريد، والأرض.
المصدر : جريدة الأيام
GMT 08:38 2020 السبت ,01 آب / أغسطس
لم تعد الحياة إلى طبيعتها بعدGMT 07:33 2020 الثلاثاء ,21 تموز / يوليو
إسـرائـيـل دون نـتـنـيـاهـوGMT 06:25 2020 الجمعة ,17 تموز / يوليو
بـيـت الـعـنـكـبـوتGMT 08:33 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو
عن فجوة "كورونا" من زاوية أخرى !GMT 12:53 2020 الجمعة ,10 تموز / يوليو
عن حكومة «كورونا» الإسرائيليةالاقتصاد العالمي يرتجف تحت ضغوط ترمب وتراجع حاد في الدولار والأسهم وسط انخفاض شعبيته
واشنطن ـ فلسطين اليوم
تراجعت أسواق الأسهم العالمية، و الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، الثلاثاء، مع تزايد الشكوك العالمية بشأن الاستثمارات الأميركية، مدفوعةً بالحرب التجارية المستمرة التي يشنها دونالد ترمب، وانتقادا...المزيدصابرين تكشف أسرار رحلتها الفنية من الغناء إلى التمثيل وتأثير الكبار في تشكيل ملامح مشوارها
القاهرة ـ فلسطين اليوم
خلال لقائها مع الإعلامية مها الصغير ضمن سهرة خاصة عُرضت على قناة CBC بمناسبة أعياد "شمّ النسيم"، فتحت الفنانة صابرين قلبها للجمهور، كاشفةً عن أسرار جديدة في مشوارها الفني، وتجاربها الإنسانية، وندمها الوحيد، وت...المزيدسكاي لاين تتهم مايكروسوفت بالمساهمة في جرائم الإبادة في غزة من خلال تقنيات ذكاء اصطناعي
واشنطن ـ فلسطين اليوم
ذكرت منظمة "سكاي لاين" الدولية أن شركة "مايكروسوفت" متهمة بالتورط في تقديم دعم تقني مباشر للجيش الإسرائيلي يفيده في جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة. وكشفت تقارير حقوقية وإعلامية أن شركة مايكروسوفت...المزيدالطاقة المخفية داخل الهرم الأكبر في الجيزة هل تحمل سرًا علميًا غير متوقع
القاهرة ـ فلسطين اليوم
الأهرامات، تلك المعجزة التي أثارت الدهشة والحيرة عبر آلاف السنين، لا تزال تحتفظ بالعديد من الأسرار التي تحير العلماء، ومن بين هذه الأسرار، كشفت دراسة حديثة أن الهرم الأكبر في الجيزة في مصر والذي يعرف بهرم خوفو قد ي...المزيدفينيسيوس يشعر بالألم من صافرات الاستهجان والأنظار السعودية تواصل الإصرار على التعاقد معه
الرياض ـ فلسطين اليوم
شرحت صحيفة "ماركا" ما اعتبرتها أسباب "برودة" النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في التعامل مع جمهور ريال مدريد، خلال مواجهة أتلتيك بلباو.النادي الأبيض تغلّب على النادي الباسكي 1-0 في الوقت المحتسب بدل الضائع ...المزيدأفضل ثمانية مشروبات صيفية طبيعية للحفاظ على رطوبة الجسم ومقاومة موجات الحر
القاهرة ـ فلسطين اليوم
يُعدّ الصيف موسماً مثالياً للحفاظ على رطوبة الجسم وتعويض السوائل المفقودة. ومع ذلك، قد يكون شرب الماء العادي مملاً للبعض. في حر الصيف الحارق، يمكنك التفكير في شرب شيء منعش لإرواء عطشك. إليك أفضل ثمانية مشروبات صيفي�...المزيدإطلالات النجمة يسرا المدهشة من فساتين الكاب إلى الجمبسوت
القاهرة ـ فلسطين اليوم
تتميز دائماً النجمة يسرا بإطلالتها الأنيقة بمختلف الأوقات، ولكن لا زالت تحتفظ بأناقتها مع مرور السنوات. واحتفالاً بعيد ميلادها قررنا أن نشارككِ أبرز صيحات الموضة التي حرصت على اختيارها النجمة يسرا بمختلف الأوقات سواء بالحفلات والمهرجانات، والتي ساعدتها في الحصول على مظهر أنيق ورائع يخطف الأنظار. الفساتين بموضة الكاب اختيار يسرا كانت فساتين السهرة بموضة الكاب من أكثر الصيحات المفضلة لدى النجمة يسرا عند ظهورها على السجادة الحمراء في مختلف دول العالم. حيث اختارت الفستان العاجي المطرز بتفاصيل ذهبية، وذلك عند حضورها حفل الأوسكار 2020. لهذا تميل دائماً لاختيار هذه الموديلات من توقيع المصممين العرب مثل زهير مراد وإيلي صعب وجورج حبيقة. اختارت أيضاً الفستان السماوي بموضة الكاب بأقمشة الشيفون بشكل ناعم مفعم بالأنوثة خلال حضورها �...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©