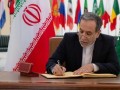الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الفلسطينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب فلسطينية
- بطولات
- أخبار الاندية الفلسطينية
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- صور
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
رؤية مغايرة للأزمة الفلسطينية

ماجد كيالي
لا تتوقّف الأزمة الفلسطينية على الخلاف السياسي بين «فتح» و «حماس»، ولا على انقسام النظام السياسي الفلسطيني، بين سلطتي الضفة وغزة، ولا على إخفاق خياري المقاومة والتسوية، أو الانتفاضة والمفاوضة، ولا على ترهل أو استهلاك كياني المنظمة والسلطة، رغم استهلاك طاقات الفلسطينيين في البحث عن الصيغ التي تمكنهم من التغلب على كل واحدة من المشكلات المهمة والمؤثرة، إذ إن أزمتهم هي أعمق وأشمل وأبعد من كل ذلك، وهذا ما يفترض أن يكون في مركز إدراكاتهم وما يجب تكريس جهودهم من أجله، بدل التجاهل أو التهرب.
هكذا، فالأزمة تتعلق برؤية الفلسطينيين لأنفسهم، ولطبيعة صراعهم مع عدوهم، وتعريفهم مشروعَهم الوطني، وتحديدهم طرق نضالهم المناسبة والمجدية، وتصورهم عن مستقبلهم، وضمن ذلك تحديدهم الأفق السياسي الراهن لكفاحهم وتضحياتهم.
مثلاً، ما الذي يريده الفلسطينيون على المدى البعيد؟ وما الذي يستطيعونه، في هذا السياق، على المدى القريب؟ ومن أجل ماذا يعانون ويضحون ويناضلون ويقاتلون ويُقتلون؟ هل من أجل البقاء عند حدود اتفاق اوسلو مع سلطة مهمشة ليس لها من السلطة شيء سوى السيطرة على شعبها؟ أو من أجل إقامة دولة مستقلة في الضفة والقطاع، لجزء من الأرض على جزء من الشعب مع جزء من السيادة؟ وهل هذه تستطيع أن تكون حقاً دولة مستقلة وأن تمثل كل الفلسطينيين، أم مطلوب منها أن تمثل فلسطينيي الأراض المحتلة (1967) فقط؟ ثم ما هو نوع الدولة الوطنية التي يطمحون إليها: استبدادية، أم ديموقراطية، وطنية أم اسلامية؟ أم انهم يريدون التحرير، وإقامة دولة واحدة من النهر إلى البحر، وطنية أو اسلامية، وتالياً طرد اليهود؟ أم يريدون دولة ديموقراطية، سواء كانت ذات طابع ثنائي القومية أو دولة مواطنين متساوين وأحرار؟
هذه هي المعضلة، التي ينبغي أن نحرّض على النقاش في شأنها مهما كانت أوضاعنا، علماً أن الفكر السياسي الفلسطيني، في اواخر الستينيات، كان ناقش هذه المسائل، لكن بدلاً من المضي بتعميقها، وإغنائها، تم تجاهلها، وتالياً النكوص عنها. مع التأكيد أن هذا النقاش عندي ينبني على اعتقاد مفاده أنه لا يوجد أفق، لاستمرار اسرائيل كدولة يهودية واستعمارية وعنصرية، أولاً، لأن الممالك الاوروبية، في القرن الحادي عشر، اجتمعت كلها على غزو المشرق العربي لكنها لم تستطع الحفاظ على مملكتها في القدس (رغم قرنين من الحروب الصليبية). وثانياً، ولأن التطورات الدولية، وتطور البشرية، والقيم الإنسانية وتداعيات عصر العولمة، تتعارض مع ذلك. وثالثاً، لأن ثمة رهاناً على نهوض مجتمعات العالم العربي. وبديهي أن هذا الاعتقاد ينسحب على فكرة التحرير، التي تتضمن «كبّ» اليهود في البحر أو طردهم، لأنها أيضاً تتعارض مع الواقع الحاصل ومع تطور البشرية وقيمها، لمصلحة إيجاد حلول استيعابية وديموقراطية، تتأسس على المواطنة والعدالة والمساواة، في تمثل للحل الذي تم تجريبه، بين المستعمر والمستعمر، في جنوب افريقيا، بعد تقويض نظام التمييز العنصري.
على ذلك فإن الفلسطينيين معنيون، في ضوء ما تقدم، بدراسة واقعهم وظروفهم وإمكانياتهم، وإمعان التفكير بكيفية صوغ رؤية جديدة لمشروعهم الوطني، بحيث يأتي مراعياً لأفق المستقبل، وظروف الحاضر، والقيم الإنسانية، واعتبارات الحقيقة والعدالة، لإعادة بناء حركتهم الوطنية وكياناتهم السياسية على هذا الأساس.
أما على المستوى الراهن، فليس لدى الفلسطينيين سوى خيارين، أولهما، استمرار الوضع الراهن، مع مجرد سلطة محدودة تتعايش مع إسرائيل، وتشتغل على أساس التنسيق الامني والتبعية الاقتصادية والمصالح السياسية معها. وثانيهما، الانقلاب على واقعهم الراهن وتحرير الكيان الفلسطيني من اتفاقات او من قيود اوسلو، بعد أن نقضتها اسرائيل أساساً، واعتباره مجرد كيان تابع للمنظمة، وتتحدد مهمته في إدارة أحوال الفلسطينيين في الداخل، لكن على أساس تنمية المؤسسات والموارد الذاتية في سياق التصارع المدروس، وليس التعايش، مع الاحتلال، وفقاً للطرق والوسائل المناسبة والمجدية.
واضح أن الخيار الأول سيؤدي الى تآكل الكيانات السياسية الفلسطينية، وأفولها، بعد أن انتهى دورها، وبعد أن تخلت هي عن معنى وجودها، كما سيؤدي ذلك الى انهيار المشروع الوطني الفلسطيني، في حين أن المشروع الثاني ربما يكون بمثابة الجسر اللازم لحمل حالة وطنية فلسطينيية جديدة، تبشر بها الأجيال الجديدة من الشباب الفلسطينيين في الداخل والخارج، التي تتطلع الى العيش في عالم أكثر حرية وعدالة وكرامة، مع أشكال وتصورات جديدة في النضال والتعبير.
وبالتأكيد، فإن وجهة النظر هذه تنطلق من فرضية مفادها استحالة، أو أقله عدم جدوى، تصور عمل فلسطيني فوق العادة، او أزيد من قدرة الفلسطينيين، التي هي محدودة أصلاً، في ظل هذه المعطيات الدولية والاقليمية غير المواتية، لاسيما في ظروف انفجار المشرق العربي، وتصدع مجتمعاته، لاسيما في العراق وسوريا. والقصد هنا أن الحديث الجاري عن انتفاضة جديدة، او عن حرب تحرير من غزة، تفتقد للمنطق، وللإمكانيات الواقعية، كما أنها ستكون عملاً يستحيل استثماره، بالقياس لتجارب الانتفاضة الثانية او لحروب غزة الثلاث، مع التأكيد أن هذه القناعة هي مجرد رأي، بمعنى أنها لا تملك قوة الفرض، ولا تستطيع كبح اية قوة ترى في إمكانها إطلاق انتفاضة او حرب تحرير، علماً ان هذا الرأي لا يشمل العمليات الفردية المتفرقة والعفوية.
أما بخصوص الحديث عن أزمة الكيانات الفلسطينية (المنظمة والسلطة والفصائل والمنظمات الشعبية)، فإن هذا يشمل الفصيلين الرئيسين المسيطرين على الموارد والمجال العام والقرار، وهما «فتح» و «حماس»، كما يشمل ما يسمى فصائل «اليسار الفلسطيني» وهذا ما يتمثل بضعف قدرتهم على إنتاج كيانات تمثيلية ومؤسسية وديموقراطية، وافتقادهم القدرة على تجديد الأفكار وبنى أشكال العمل، واستمراء العيش على الماضي، من دون الاستفادة من تجربة، أو من خبرة، كفاحية عمرها نصف قرن، بما لها وما عليها.
والحال فإن مشكلتنا مع الفصائل، أيضاً، أنها باتت بمثابة كيانات مغلقة، ولم تعد تمثل تيارات ذات بعد شعبي، كما كانت، وانها تفتقد للحراكات الداخلية وللحياة الديموقراطية، فثمة طبقة متسيدة فيها، في الأغلب لم تعد تضيف شيئاً لكفاح الفلسطينيين لا على صعيد التفكير السياسي ولا طرائق النضال، وانها وإن في شكل متفاوت، ترهلت وتراجعت مكانتها، في مواجهة اسرائيل، وانحسرت مكانتها، في مجتمعات الفلسطينيين.
مثلاً، فإن المشكلة في «فتح»، كتيار وطني، أنها كفّت عن كونها حركة وطنية تعددية متنوعة، وأنها بعد أن كانت الحركة الأكثر شبهاً بشعبها، أضحت بمثابة حزب للسلطة، تحتكر الموارد والتقرير بالخيارات، وانها نكصت عن مشروعها الوطني نحو حل لجزء من الشعب على جزء من الأرض، دون أن تحاول شق أي أفق آخر، ومن دون أن تحاول نفض التكلس والكسل في بدنها؛ رغم فشل خيار المفاوضة وتعثر كيان السلطة. والمشكلة في «حماس»، أنها تشتغل كتيار ديني أكثر مما تشتغل كتيار وطني، وأنها تحولت الى سلطة في غزة، تهيمن على حياة الفلسطينيين، وفي شكل أحادي، وبوسائل القسر، وبدعوى تطببق الشريعة، وأنها تتصرف في السياسة للبناء على موازين القوى والمعطيات العربية والدولية وانما بروح قدرية، لا تأخذ في اعتبارها معاناة الفلسطينيين في غزة وتضحياتهم. أما المشكلة مع فصائل اليسار فهي أنها أيديولوجية (مع أن هذه الكلمة كبيرة عليها)، وانها أضحت بمثابة فصائل معزولة، وبيروقراطية، فضلاً عن انها مشتتة، وهي لا تشتغل لتوحيد ذاتها، مع انه لا يوجد مبرر لبقائها متوزعة على عدة فصائل، غير نظام «الكوتا»، مع ضعف أهلية قيادتها، لا سيما انها تفتقد إلى الديموقراطية وللحراكات الداخلية ايضاً. والمشكلة الأهم أن هذه الفصائل لم تعد تضيف شيئاً البتّة، وقد قل تأثيرها في العمل الفلسطيني، وعلى الرأي العام، فضلاً ان سياساتها غالباً ما تتبع «فتح» أو «حماس»، ناهيك بأنها تقف مع نظام الاستبداد في سوريا، ومع إيران، وتتنكّر لعذابات الشعب السوري وتضحياته وطلبه على الحرية والكرامة، مع فصلها بين مفهومي التحرير والحرية.
لا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بمعالجات جذرية وشاملة، وهو أمر صعب ومعقّد لاسيما في هذه الظروف، مع خراب المشرق العربي، وارتهان الكيانات الفلسطينية للإرادات الخارجية، وتشتت أوضاع الفلسطينيين والمصاعب التي تواجهها مجتمعاتهم، مع ذلك فكلما كان ذلك أقرب، ولو بالتدريج، كان أجدى وأفضل.
GMT 05:42 2025 الأربعاء ,02 إبريل / نيسان
طلعت حرب أم سفاح التجمع؟!!GMT 05:40 2025 الأربعاء ,02 إبريل / نيسان
اعترافات ومراجعات 100 قائد عسكرى ورمز دبلوماسىGMT 05:39 2025 الأربعاء ,02 إبريل / نيسان
علاقات سياسية معقدةGMT 05:38 2025 الأربعاء ,02 إبريل / نيسان
ما سمعناه.. وما نراهGMT 05:29 2025 الأربعاء ,02 إبريل / نيسان
خلافة ترامب!GMT 05:28 2025 الأربعاء ,02 إبريل / نيسان
أخلاق مبهوأة!GMT 05:27 2025 الأربعاء ,02 إبريل / نيسان
شجرة التطرف الوارفة (الأخيرة)GMT 01:03 2025 الأربعاء ,02 إبريل / نيسان
صلاة الفجر في مكةانخفاض أسعار المستهلك في غزة وارتفاعها في القدس والضفة خلال شباط 2025
غزة ـ فلسطين اليوم
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة تراجع ليسجل انخفاضاً مقداره 33.29% خلال شهر شباط 2025 مقارنة بشهر كانون ثاني 2025، فيما سجل المؤشر ارتفاعاً في القدس بنسبة 0.50%، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% في ا...المزيدجدل في ليبيا حول اختيار غادة عادل لحملة إعلانية لمتحف وطني
القاهرة ـ فلسطين اليوم
تعرّضت الفنانة غادة عادل لانتقادات كثيرة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بعد مشاركتها في الحملة الإعلانية لإعادة افتتاح المتحف الوطني في العاصمة طرابلس، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة فيه. وجاءت الا�...المزيدفضيحة جديدة في البيت الأبيض بسبب استخدام بريد جيميل في مراسلات رسمية
واشنطن ـ فلسطين اليوم
استخدم مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز حسابه الخاص على بريد "جيميل" الإلكتروني في مراسلات رسمية، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".وتأتي هذه الفضيحة بعد أسبوع من خرق أمني فاضح هز البيت الأبيض، وكان ...المزيدالطاقة المخفية داخل الهرم الأكبر في الجيزة هل تحمل سرًا علميًا غير متوقع
القاهرة ـ فلسطين اليوم
الأهرامات، تلك المعجزة التي أثارت الدهشة والحيرة عبر آلاف السنين، لا تزال تحتفظ بالعديد من الأسرار التي تحير العلماء، ومن بين هذه الأسرار، كشفت دراسة حديثة أن الهرم الأكبر في الجيزة في مصر والذي يعرف بهرم خوفو قد ي...المزيدإيمان خليف تؤكد استعدادها للدفاع عن لقبها الأولمبي وتوجه رسالة حاسمة لترامب
الجزائر ـ فلسطين اليوم
أعلنت إيمان خليف، الحائزة على الميدالية الذهبية في الملاكمة في أولمبياد باريس، الأربعاء، عزمها الدفاع عن لقبها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، موجهة رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكدت فيها أنها ليست متحولة جنسي�...المزيدأمل جديد لمرضى بطانة الرحم المهاجرة أول أقراص يومية توفر بديلا فعالا للحقن التقليدية
واشنطن ـ فلسطين اليوم
وافقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على أول أقراص يومية لعلاج طويل الأمد لمرض بطانة الرحم المهاجرة (الانتباذ البطاني الرحمي)، بحسب تقرير لشبكة «سكاي نيوز».ويمكن أن يُساعد هذا الدواء نحو ألف امرأة سنوياً يعا�...المزيدالملكة رانيا تتألق بعباءة وردية مطرزة بلمسات تراثية تناسب أجواء رمضان
القاهرة ـ فلسطين اليوم
الإطلالات التراثية الأنيقة المزخرفة بالتطريزات الشرقية، جزء مهم من أزياء الملكة الأردنية رانيا ترسم بها هويتها في عالم الموضة. هذه الأزياء التراثية، تعبر عن حبها وولائها لوطنها، وتعكس الجانب التراثي والحرفي لأبناء وطنها وتقاليدهم ومهاراتهم في التطريز الشرقي. وفي احدث ظهور للملكة رانيا العبدالله خلال إفطار رمضاني، نجحت في اختيار إطلالة تناسب أجواء رمضان من خلال تألقها بعباءة بستايل شرقي تراثي، فنرصد تفاصيلها مع مجموعة من الأزياء التراثية الملهمة التي تناسب شهر رمضان الكريم. أحدث إطلالة للملكة رانيا بالعباءة الوردية المطرزة بلمسات تراثية ضمن اجواء رمضانية مميزة يملؤها التآلف، أطلت الملكة رانيا العبدالله في إفطار رمضاني، بعباءة مميزة باللون الوردي تميزت بطابعها التراثي الشرقي بنمط محتشم وأنيق. جاءت عباءتها بتصميم فضف�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©